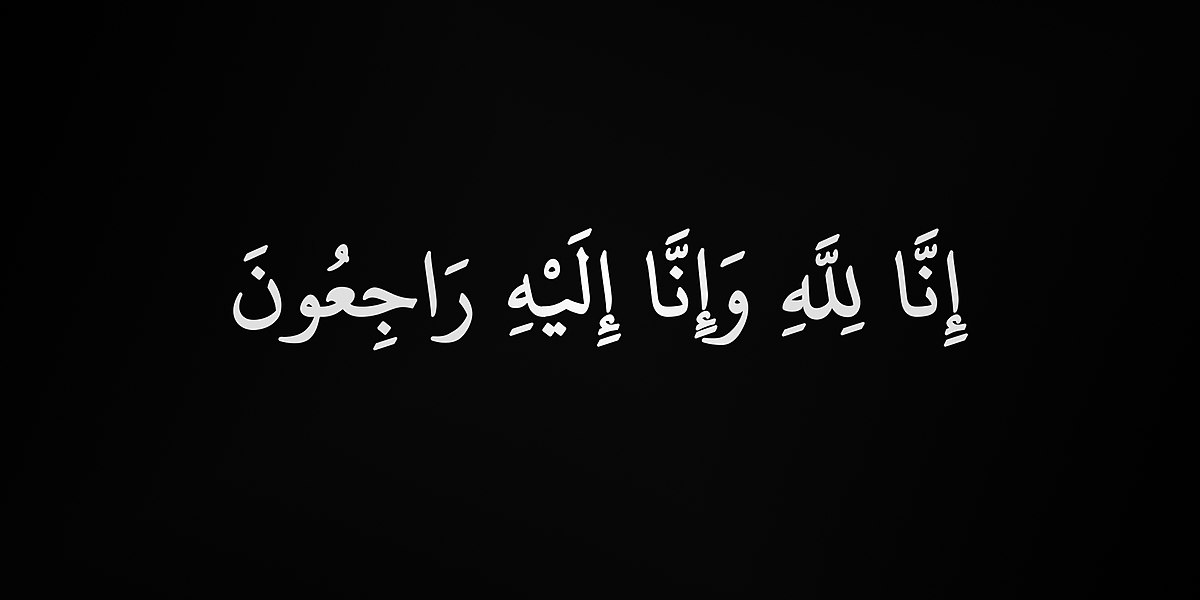آراء و مقالات

صوت عمان :
بقلم الدكتور أحمد حسن شديفات
تتكرّر في المشهد العام ظاهرة تستحق التوقّف: مسؤولون يغادرون مواقعهم، ثم يظهرون فجأةً بجرأة نقدية لم نرَ لها أثرًا حين كانت بين أيديهم مفاتيح السلطة الفعلية. وما إن ينطفئ ضوء المكتب ويُغلق الباب، حتى تبدأ مرحلة يمكن وصفها بحق بـ «مراهقة ما بعد السلطة»؛ تصريحات مرتفعة النبرة، وتحليلات مُدهشة، وكأنهم لم يكونوا بالأمس جزءًا أصيلًا من القصة.
المفارقة الأكثر إيلامًا أنّ بعض هؤلاء لم يحرّك ساكنًا إزاء تضخّم المديونية أو تراجع الأداء العام خلال سنوات ولايتهم، بينما يخرج اليوم بصورة «الخبير المستقل» الذي يملك كل الإجابات. فيبدو وكأنّ المسؤول لم يكن مسؤولًا، وكأننا نناقش شخصًا لم يجلس يومًا على الكرسي ولم يوقّع قرارًا واحدًا.
وهنا يثور السؤال المشروع:
هل كان النفوذ مجرد بريق كرسي يفقد سحره عند مغادرته؟ أم أنّ الخلل في من جلس عليه ولم يجرؤ على استخدام صلاحياته حين كانت الكلمة له، والقرار بيده، والفرصة متاحة للتغيير؟
هذه الظاهرة لا تكشف ضعفًا في الممارسة فحسب، بل تكشف هشاشةً في الضمير السياسي؛ إذ لا معنى لخطابة عالية بعد الرحيل إذا كان زمن الفعل قد ضاع في الصمت والتردّد. ولو أنّ المسؤول واجه الحقائق بشجاعة أثناء وجوده في السلطة، لما اضطرّ اليوم للّجوء إلى لغة التبرير أو الحكمة المتأخرة.
إنّ الرأي العام لم يعُد يقبل أن يتحوّل المسؤول السابق إلى ناقدٍ شرس لمرحلة كان هو أحد صانعيها. فالذاكرة المجتمعية ـ مهما حاول البعض تهميشها ـ لا تُصاب بفقدانٍ مؤقت، ولا تُختزل في خطاب إعلامي بعد نهاية الخدمة
اقرأ أيضا
-
 السردية للدولة ماذا ولماذا؟2025-11-27
السردية للدولة ماذا ولماذا؟2025-11-27